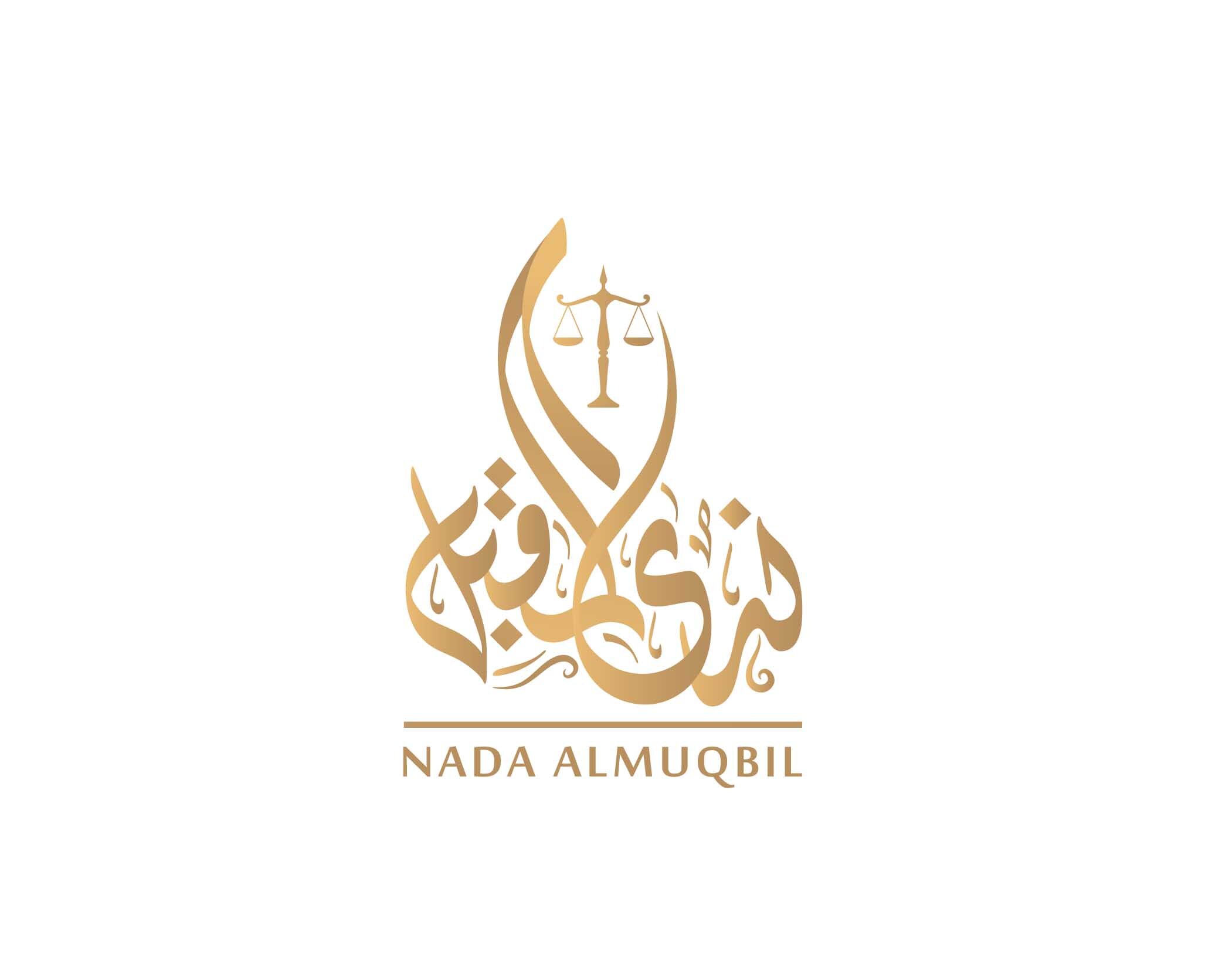حق الاستعانة بمحامٍ في السعودية: أين يتعطل الحق؟ وكيف نُصلحه؟

أحمد العطاس
November 4, 2025
November 4, 2025
November 4, 2025
تمت المراجعة بواسطة
أثير الزهراني
نبذه عن المؤالف

أحمد العطاس
عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق، باحث دكتوراه قانون، مهتم في تداعيات الذكاء الاصطناعي في القانون الجنائي وتحديداً جرائم الأوراق المالية.
مقدمة
تقريباً كل من يعمل في المحاماة يفاجَأ يوماً بذلك الاتصال العاجل من أبٍ قَلِق أو أمٍّ مذعورة: «الحقْنا، ولدنا في الشرطة». في تلك اللحظة تتمنى أن يحالفك الحظ وأن يكون لدى الابن وكالة شرعية سابقة لوالده، أو أن تكون بيانات دخول «نفاذ» متاحة لدى والده (منصة النفاذ الوطني الموحّد للدخول على الخدمات الحكومية). إن لم يتوافر ذلك، ستبقى مكفوف اليدين أيّاماً، وأحياناً لأسابيع، حتى تُستخرج لك وكالة جديدة لتبدأ عملك. وهذا أمر مؤسف لأن لحظات القبض الأولى تُعدّ من أكثر المراحل حساسية وحسماً في القضايا الجنائية، ومع ذلك يتعذّر غالباً حضور المحامي فيها بسبب هذه العقبة الإجرائية التي سيعرضها هذا المقال.
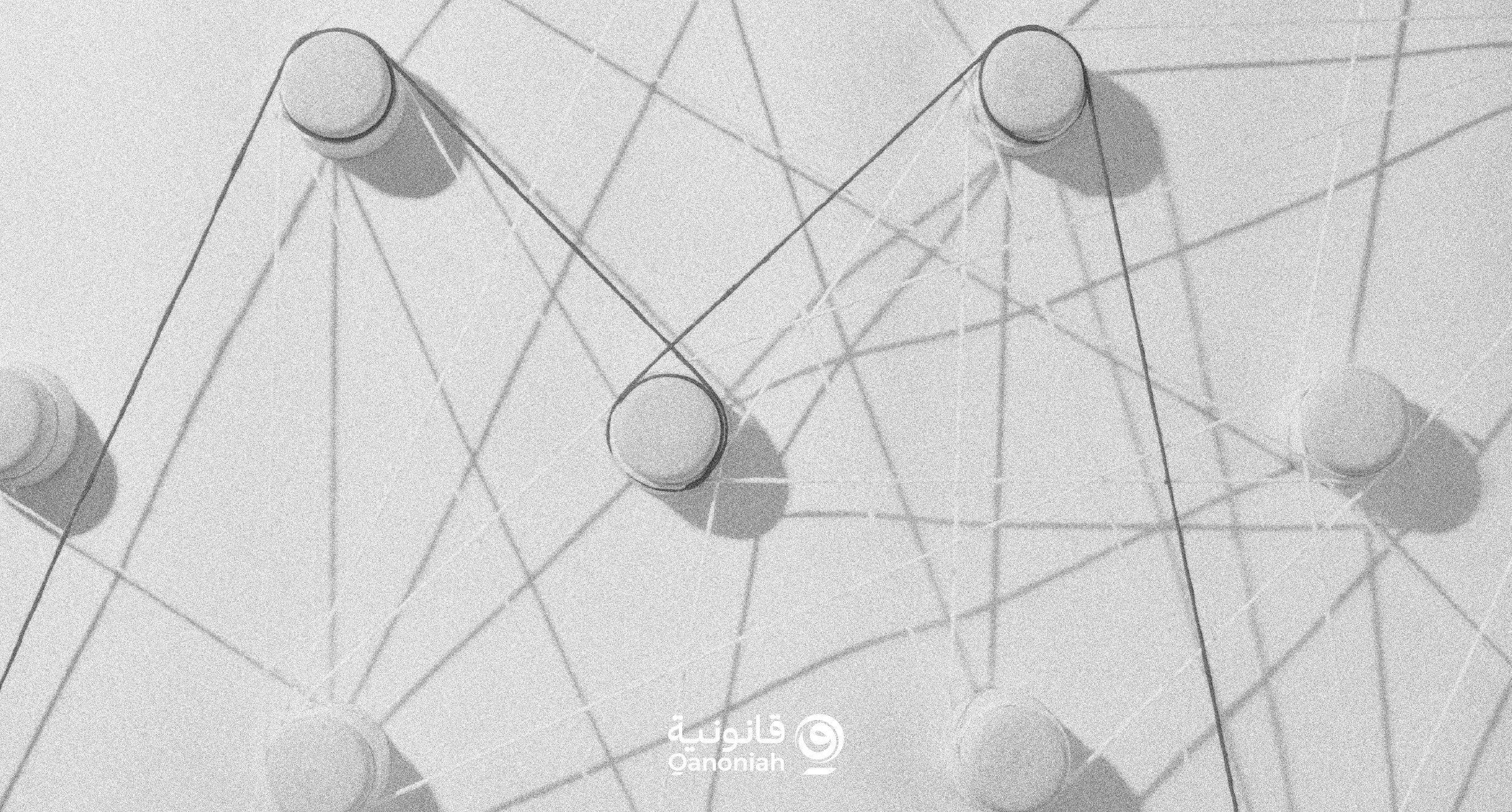
العقبة الإجرائية في حضور المحامي
رغم وضوح النصّ النظامي، إلا أنّ تطبيق هذا الحق يصطدم كثيراً بشرطٍ إجرائي يتمثل في ضرورة وجود «وكالة شرعية» تُخوِّل المحامي تمثيل الموقوف. وهذه الوكالة لا تُستخرج إلا عبر «ناجز» (منصة وزارة العدل للخدمات العدلية الالكترونية) أو عن طريق مُوَثِّق/كاتب عدل (الجهة المختصة بتوثيق الوكالات)، وهذان المساران يخلقان للمتهم عقبات عملية متعددة.
أ. استخراج الوكالة عبر "ناجز":
فمنها أن المتهم الموقوف لا يستطيع الدخول إلى منصة «ناجز» لأنها تتطلب اتصالاً بالإنترنت، وهذا يعني الحاجة إلى هاتف أو حاسوب، وكلاهما ممنوع داخل السجن أو دار التوقيف. وقد يحاول أن يطلب من أحد أفراد أسرته الدخول نيابة عنه، لكن هذا الحل يفتح مشكلات أخرى. أول مشكلة أن الدخول إلى «ناجز» يحتاج إلى «الرمز المرسل للهاتف» (رمز التحقق لمرة واحدة)، وهذا الرمز يكون في الغالب مرتبطاً بهاتفٍ تحت يد الجهة المختصة، فلا يستطيع الموقوف ولا أسرته الوصول إليه. المشكلة الثانية، وهي التي لا ينتبه لها كثيرون، تتعلق بخصوصية الموقوف؛ فاضطراره إلى تسليم بياناته السرية، مثل كلمة المرور أو بيانات حسابه في «ناجز»، لأحد أفراد أسرته يمسّ حقه في الخصوصية. والإنسان الأصل أن تُصان معلوماته، لكن في هذه الظروف الطارئة يجد نفسه مضطراً إلى كشفها لأنه لا يوجد طريقٌ عاجلٌ آخر.
ب. عبر "الموثّق" أو "كاتب العدل":
والمسار الآخر هو استخراج الوكالة عبر «موثّق» أو «كاتب عدل» غير أن هذا المسار مقيّد بطبيعة الحال بعدة عقبات عملية؛ فالموثّق أو كاتب العدل لا يستطيع الحضور إلى السجن في أي وقت، ومواعيد حضورهم تختلف من سجنٍ إلى آخر، إضافةً إلى أن خدمة التوثيق تتطلب رسوماً مالية. ورغم مبادرات وزير العدل لتحسين الوضع، مثل تفعيل خدمة إصدار الوكالات للنزلاء عبر الاتصال المرئي، فهي ما زالت تعالج الأعراض لا أصل المشكلة؛ لأنها تعتمد في جوهرها على «الكادر البشري»، حضورياً أو عن بُعد، وهذا الكادر محدودٌ ومشروطٌ بعوامل كثيرة كجداول المناوبات، والإجازات، وإجراءات الدخول للمنشآت الإصلاحية، وتوفر الاتصال التقني، وأي تعثّر في واحد من هذه العوامل يعني مزيداً من التأخير. وحتى لو استُبدل الاعتماد على الأفراد بأجهزة داخل السجون تمكّن الموقوف من إصدار وكالته ذاتياً، فلن تُحقق الفاعلية المطلوبة إلا إذا ضُمِن توفّرها في جميع السجون، وتأكيد جاهزيتها الدائمة وصيانتها المستمرة، مع تدريب العاملين على تشغيلها؛ وإلا عادت المشكلة في صورتها الأولى.
الأثر العملي لتأخر الوكالة على الموقوف
منذ اللحظة الأولى للقبض وإيقاف المتهم لا يستطيع المحامي الوصول إليه على وجه السرعة، لأن استخراج الوكالة يحتاج وقتاً لا مفر منه. كل الحلول المتاحة اليوم قد تُخفِّض المدة قليلاً، لكنها تبقى طويلة نسبياً بالنسبة للموقوف نفسه. وهنا يجب أن ننتبه لاختلاف الإحساس بالوقت. فما يعدّه الناس خارج التوقيف «ثلاثة أو أربعة أيام عابرة» ليس كذلك لمن هو مقيّد الحرية، ينتظر خبراً أو خطوة عملية، ويريد حلاً مباشراً يمكّنه من رؤية محاميه والتصرف فوراً. هذا الفرق في الإحساس بالزمن هو جوهر المشكلة، لأنه يحوّل الانتظار القصير في نظر العامة إلى عبء ثقيل في نظر الموقوف.
هذا الفراغ الزمني يفتح الباب أمام قلق نفسي متصاعد لدى المتهم وذويه. الأسرة تتلقّى شذرات من المعلومات ولا تعرف ماذا يجري بدقة، والمتهم نفسه يشعر بالعزلة لأنه لا يستطيع توكيل محامٍ إلا بعد اكتمال إجراءات الوكالة. ومع غياب المحامي في هذه الساعات والأيام الأولى، يغلب الشعور بالعجز على الجميع، فالموقوف ينتظر، وأسرته تترقّب، والمحامي يعرف ما ينبغي فعله لكنه مقيَّد بعقبة إجرائية لا يملك تجاوزها قبل اكتمال التوكيل.
ويمتد أثر هذا التأخير إلى مدة الإيقاف نفسها؛ فالمحامي لا يستطيع تقديم طلب الإفراج في حينه ما لم يكتمل توكيله رسمياً. وكل يوم تأخير في استخراج الوكالة يعني يوماً إضافياً قبل أن يُرفَع الطلب، ويوماً إضافياً قبل النظر فيه. وهكذا يتحوّل الإجراء الشكلي إلى سبب عملي يطيل أمد التوقيف، فقط لأن نقطة البداية تأخرت.
وتضعف حماية الموقوف أثناء التحقيق في ظل غياب المحامي عن تلك اللحظات الأولى. هنا يبرز خطر التوقيع على أقوال أو إقرارات دون إدراكٍ كافٍ لآثارها النظامية لاحقاً. ليس المقصود أن الموقوف يقرّ بما لا يريد، وإنما أنه يتعامل مع أوراق ومسارات إجرائية حسّاسة دون وجود من يشرح له تبعات كل خطوة ويوجّه قراره على بيّنة، في مرحلة تُبنى عليها كثير من تفاصيل القضية لاحقاً. كما أن هذا التأخير يبدّد فرصاً مبكرة للدفاع قد لا تتكرر. الشهود الذين يمكن الوصول إليهم سريعاً قد تتبدّل ظروفهم أو تتراجع ذاكرتهم مع الوقت. والتسجيلات أو البيانات التي يسهل حفظها في الساعات الأولى قد تكون عرضة للفقدان أو التلف أو التغيّر مع مرور الأيام. اللحظة المبكرة مهمة لأنها لحظة للآثار الطازجة إن حاز التعبير، وكل تأخير يقلّل من حدة هذه الآثار وفرص الاستفادة منها.
ويُلقي التأخير بثقله على إعداد استراتيجية الدفاع أيضاً. فبدلاً من بناء خطة هادئة متدرجة من اليوم الأول، يجد المحامي نفسه عند اكتمال الوكالة أمام وقتٍ مضغوط لتعويض ما فاته. هذا الضغط يقود إلى تحضيرٍ ناقص بالضرورة، وإلى دفوعٍ تُقدَّم على عجلٍ في الجلسات الأولى قبل أن تأخذ حقّها من الدراسة والتمحيص. وعندما تكون البداية مرتبكة، تنعكس الارتباكة على بقية المسار. بهذه الصورة لا يكون الإشكال في «أيام» بقدر ما هو في «متى تقع هذه الأيام»؛ إذ تقع في أكثر اللحظات حساسية من عمر القضية الجنائية. ولذلك يبدو التأخير بسيطاً في ظاهره، لكنه ثقيل الوطأة في أثره.
.webp)
الحل الجذري لمشكلة تأخر إصدار الوكالة للمحامي
ويتحقق الحلّ الجذري لهذه المشكلة بتفعيل «الوكالة الشفهيّة» ضمن نطاقٍ محدّد وواضح: يحضر المحامي إلى الجهة المختصة حيث يُوقَف المتهم، يعلن المتهم صراحةً موافقته على أنه محاميه، فتُعامل هذه الموافقة منذ تلك اللحظة على أنها وكالة مبدئية تخوّل المحامي البدء في الخطوات الأولى اللازمة للدفاع. بهذه الآلية لا يتبدّد الوقت الحرج في انتظار الوكالة الورقية، بل يستطيع المحامي الدخول على الفور، زيارة الموقوف، والتواصل معه، وتمهيد المسار للإجراءات الأولية. هذا الحل معمولٌ به في عددٍ من الأنظمة المقارنة، وفي مقدّمتها النظام القانوني الأمريكي، لأنه يرفع الحواجز العملية أمام أصل الحق: «حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ»، خصوصاً في الساعات والأيام الأولى التي تتشكل فيها ملامح الملف.
جوهر الفكرة أن «الوكالة الشفهية» ليست بديلاً دائماً عن الوكالة النظامية، لكنها جسرٌ سريع يعقد الصلة القانونية بين الطرفين لحظياً. بمجرد انعقاد هذه الصلة، يستطيع المحامي مباشرة ما يلزم في الحدود الأولية التي وُضعت لها هذه الوكالة، مثل الزيارة الفورية للموقوف، وتقديم طلبات الإفراج العاجلة، وطرح نقاط الدفاع الأولى التي تحفظ وضع المتهم وتقيه تبعات القرارات المتسرعة. وكل هذه التصرفات تقع في دائرة «التصرفات النافعة نفعاً محضاً» للمتهم، فلا تطال هذه الوكالة للتصرف بحقوقه المالية، ولا يفتح باب تصرفات عامة أو بعيدة عن موضوع الإيقاف، وإنما يقتصر على الحدّ الأدنى الذي يضمن تفعيل حقه في الدفاع عملياً منذ اللحظة الأولى.
وقد تُثار حول هذا الحلّ اعتراضاتٌ نظرية تبدو مؤثرة على الورق، لكنها ضعيفة الأثر في الواقع العملي. فيُقال مثلاً كيف نتيقّن من موافقة المتهم عليه؟ وكيف نقبل مراسلات أو إفاداتٍ يقدّمها المحامي نيابة عن موكله قبل وجود مستندٍ ورقي؟ هذا النمط من الأسئلة يهدف إلى حماية النظام الإجرائي من الانفلات، وهو مقصدٌ مشروع، غير أن طبيعة «الوكالة الشفهية» المقترحة تجيب عنه من أساسه، لأنها وكالةٌ استثنائيةٌ ومحصورة بالموقوف، ونطاقها محدودٌ بدقة، فلا تمنح المحامي أي صلاحياتٍ عامة، ولا تجيز له القيام بأعمالٍ خارجة عن دائرة الدفاع الأولي.


.png)
.webp)

.webp)